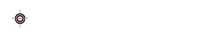11 فبراير بين ضجيج الذكرى وصمت النتائج
تمر السنوات ثقالًا، ومع كل ذكرى لنكبة 11 فبراير 2011 في اليمن، يعود الجدل كأن الزمن لم يتحرك خطوة واحدة إلى الأمام. يخرج خصوم اليمن والزعيم الشهيد علي عبد الله صالح ليجددوا الهجوم ذاته، بالكلمات نفسها، وبالنبرة نفسها، وكأنهم ما زالوا يعيشون في خنادق ذلك العام. يتصرفون كأن المعركة لم تنتهِ، أو لعلها لم تُحسم في داخلهم بعد. غير أن السؤال الذي يسبق الهتاف ويتقدم على الخطاب يبقى بسيطاً ومحرجاً: ماذا قدمتم للوطن بعد أن هدمتم ما كان قائماً؟
نعلم جميعًا أن الخلاف السياسي أمر طبيعي، بل صحي، في أي بلد يحترم نفسه. لكن ما نشهده ليس مجرد اختلاف في الرأي، بل حالة إنكار طويلة الأمد، وخوف واضح من المقارنة بين زمنين: زمن كانت فيه الدولة قائمة بمؤسساتها، بجيشها، بقرارها السيادي، وبوحدتها التي لم تكن مادةً للجدل اليومي، وزمن تلاه تراجع في هيبة الدولة، وتعدد في مراكز النفوذ، وتآكل في الإجماع الوطني حتى أصبح الوطن نفسه موضوع نزاع.
نعم، قد يختلف اليمنيون في تقييم مرحلة ما قبل 2011، وهذا حقهم، لكن كثيرين يتفقون على حقيقة لا يمكن إنكارها: كانت هناك دولة. كانت الوحدة الوطنية واقعاً معاشاً لا شعاراً انتخابياً، وكانت المؤسسة العسكرية إطاراً جامعاً لا ساحة صراع مفتوح. لم تكن الأمور مثالية، ولا يدّعى أحد الكمال، لكن سقف الدولة كان قائماً، ولم يكن الوطن مهدداً في كيانه كما هو اليوم.
عندما رُفعت شعارات التغيير والإصلاح وبناء الدولة المدنية، بدت الكلمات براقة، جذابة، قادرة على تحريك الشارع. غير أن الدولة لا تُبنى بالكلمات، بل بالمؤسسات، ولا تُدار بالعاطفة، بل بالحكمة والتوازن. ما حدث بعد 2011 لم يكن انتقالاً منظماً إلى وضع أفضل، بل انزلاقاً تدريجياً نحو هشاشة سياسية وأمنية فتحت الباب لصراعات متداخلة وأجندات متناقضة. ارتفع الخطاب، وانخفضت الأرض تحت الأقدام.
كلما جرى حديث هادئ عن إنجازات الدولة في عهد الشهيد الزعيم علي عبدالله صالح، تعلو أصوات الاتهام والتخوين، كأن استحضار الماضي جريمة بحد ذاته. السبب ليس في الماضي، بل في الحاضر. المقارنة موجعة، لأنها تضع الشعارات في مواجهة النتائج، والنتائج لا تُجامل أحداً. من يريد من الناس أن ينسوا مرحلة، عليه أن يمنحهم مرحلة أفضل، لا أن يطلب منهم تمزيق ذاكرتهم.
عليهم هنا أن يدركوا أن استدعاء تجربة الزعيم الشهيد علي عبدالله صالح ليس حنيناً أعمى، ولا محاولة للعيش في زمن مضى، بل تذكير بأن فكرة الدولة الجامعة كانت ممكنة، وأن الاستقرار لم يكن وهماً، وأن الوحدة لم تكن مجرد عبارة في خطاب رسمي. هو تذكير بأن الدولة حين تكون موجودة يشعر المواطن بظلها، حتى لو اختلف معها، وحين تغيب يدرك قيمتها ولو متأخراً.
اليمن ،اليوم، لا يحتاج إلى اجترار خصومات فبراير، ولا إلى إعادة تدوير لغة التخوين. يحتاج إلى خطاب مسؤول يعيد الاعتبار لمفهوم الدولة، ويضع مصلحة الوطن فوق الحسابات الضيقة. الشعوب لا تعيش على الصراخ، بل على الإنجاز. لا تطمئنها العواطف، بل تطمئنها النتائج. ومن حق اليمنيين أن يسألوا: أين الدولة التي وُعدنا بها؟ وأين الازدهار الذي قيل إنه ينتظر خلف إسقاط النظام؟
المشكلة ليست في الذاكرة، بل في الخوف من المقارنة. من يثق بمشروعه لا يخشى التاريخ، بل يواجهه ويضيف إليه صفحة جديدة مشرقة. أما من لم يقدم سوى الانقسام والضعف والسلالية و العنصرية واسقاط اليمن في تحت البند السابع و الوصاية و مشاريع الانفصال، فسيظل أسير الضجيج، يهاجم الماضي لأنه عاجز عن صناعة حاضر أفضل. والتاريخ، في النهاية، لا يُمحى بالصوت العالي، بل يُكتب بالعمل، ويُحسم بالنتيجة.