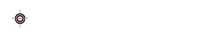من رأس الأفعى إلى صنعاء… حين تغيب الدراما ويحضر التطرف
لا أذكر أن عملاً درامياً أثار كل هذا الجدل منذ سنوات كما فعل مسلسل رأس الأفعى، والجدل في البلاد العربية، حين يكون حول الوعي لا حول الفضائح، علامة صحة لا مرض. منذ الحلقات الأولى بدا واضحاً أن العمل تجاوز حدود التسلية إلى مساحة أخطر وأهم: مساحة تفكيك السرديات التي عاشت طويلاً في الظل، وفي مقدمتها سردية جماعة الإخوان المسلمين التي أتقنت عبر عقود فن مخاطبة العاطفة، وتجنبت دائماً مواجهة الأسئلة الصعبة.
الهجوم الذي شنّته منصات محسوبة على الجماعة لم يفاجئني. من يخشى الضوء يهاجم المصباح. الدراما حين تدخل إلى البيوت العربية، تفعل ما لا تفعله الخطب السياسية ولا البيانات الحزبية. هي تخاطب الأسرة كلها بلغة الصورة، وتعيد ترتيب الذاكرة الجمعية، وتطرح الوقائع في قالب فني يجعلها أقرب إلى الفهم وأصعب على التزوير. لذلك كان الارتباك سريعاً، وكان التشكيك متوقعاً، لأن إعادة قراءة التاريخ أمام جمهور واسع ليست تفصيلاً عابراً في معركة الوعي، بل هي صلب هذه المعركة.
أنا من الذين يعتقدون أن مواجهة الفكر المتطرف لا تُحسم في قاعات المحاكم وحدها، بل في عقول الشباب. التنظيمات الأيديولوجية تعيش على فكرة الاحتكار: احتكار الحقيقة، واحتكار تفسير الدين، واحتكار الوطنية. وعندما يأتي عمل فني ليقول إن الحقيقة أوسع، وإن الوطن ليس ملكاً لتنظيم، يبدأ القلق.
الشباب العربي اليوم يقف في مفترق طرق؛ بين خطاب يعده بالخلاص عبر شعارات براقة، وخطاب وطني يدعوه إلى التفكير والسؤال والمساءلة. وإذا لم نحصّن هذا الشباب بالمعرفة والنقاش الصريح، تركناه فريسة سهلة لمن يتقنون استثمار المظلومية وتغليف السياسة بلباس العقيدة.
ان نجاح مسلسل “رأس الأفعى” جماهيرياً لم يكن مصادفة، بل تعبيراً عن تعطش عام إلى دراما تحترم عقل المشاهد. التفاف الأسر المصرية والعربية حوله منذ اللحظة الأولى يعكس ثقة متجددة في قدرة الدراما المصرية على الجمع بين الحبكة المتقنة والرسالة العميقة.
ومصر، التي عرفت تاريخياً بأنها قلب الإبداع العربي، تدرك أن قوتها الناعمة ليست ترفاً ثقافياً، بل جزءاً من أمنها القومي. حين تستعيد القاهرة موقعها الطبيعي كرافعة أساسية للإعلام العربي، فهي تعيد التوازن إلى مشهد اختلطت فيه الأصوات، وكثرت فيه المنابر التي تبيع الوهم باسم الفضيلة.
غير أن معركة الوعي لا تقتصر على تفكيك خطاب الإخوان، بل تمتد إلى فضح كل مشروع يسعى إلى اختطاف الدولة والمجتمع باسم السماء. وإذا انتقلنا إلى اليمن، وجدنا الصورة أكثر إيلاماً وأشد وضوحاً في آن واحد. هناك، يعيش الشعب اليمني بين فكي مشروعين متناقضين في الشكل، متشابهين في النتيجة. مشروع يرفع شعار “الولاية” ويحتكر الحق الإلهي في الحكم، تمثله مليشيا الحوثي الارهابية، ومشروع آخر يلوّح براية “الخلافة” ويعيد إنتاج خطاب الجماعة العابرة للحدود، وفي مقدمها حزب التجمع اليمني للإصلاح المرتبط فكرياً بالإخوان.
النتيجة واحدة: دولة غائبة، ومجتمع ممزق، وشباب ضائع بين شعارات دينية متناقضة تتصارع على السلطة وتنسى الإنسان. الأعجب أن الدراما اليمنية، في معظمها، وقفت بعيداً عن هذا الواقع المشتعل. لم تجرؤ على تسمية الأشياء بأسمائها، ولم تناقش بموضوعية ووضوح مخاطر الفكر الإخواني ولا خطر المشروع الحوثي الطائفي. كأن الفن قرر أن يعيش في قرية افتراضية لا حرب فيها ولا حصار ولا انقسام، فيما المواطن اليمني يدفع الثمن كل يوم.
الحقيقة المؤلمة أن كثيراً من المسلسلات اليمنية انشغلت بالكوميديا السطحية أو الموضوعات الهامشية، وابتعدت عن جوهر المأساة. لم تتعلم من التجربة المصرية أن الدراما يمكن أن تكون أداة كشف لا أداة هروب، وأن الفن حين يلامس الجرح يساعد على الشفاء، لا على تعميق النزيف. الشجاعة ليست في رفع الصوت، بل في مواجهة الواقع كما هو، وفي طرح الأسئلة التي يخشاها السياسي قبل الفنان.
اليمن اليوم ليس بحاجة إلى مسلسلات تزيّن الخراب، بل إلى أعمال تضع المرآة أمام المجتمع، وتقول للشباب بوضوح إن ما يحدث ليس قدراً منزلاً، بل نتيجة أفكار متطرفة ومشاريع أيديولوجية متصارعة على السلطة باسم الدين. حين يفهم الشاب اليمني أن مشروع “الولاية” ومشروع “الخلافة” وجهان لعملة واحدة عنوانها احتكار الحقيقة وإقصاء الآخر، يبدأ أول الطريق نحو استعادة الدولة.
في المقابل، لا بد من تثبيت البوصلة الأخلاقية للأجيال الجديدة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية. هنا يبرز مسلسل صحاب الأرض الذي يُعرض عبر قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في شهر رمضان، نموذجاً لدراما لا تهرب من الواقع. العمل يسلط الضوء على معاناة الفلسطينيين في قطاع غزة، ويذكّر بأن فلسطين ليست شعاراً موسمياً، بل قضية عدل وهوية.
تكريس فلسطين في وعي الشباب العربي لا يتناقض مع مواجهة التطرف الداخلي، بل يكمله. فالشاب الذي يفهم عدالة قضيته القومية، ويدرك في الوقت نفسه خطورة المشاريع الأيديولوجية المغلقة في بلده، يصبح أقل عرضة للانجرار خلف الشعارات الخادعة. الوعي لا يتجزأ، والهوية لا تُبنى على نصف حقيقة.
المعركة اليوم، في رأيي، هي معركة رواية ومعركة شجاعة. من يملك القدرة على سرد القصة بصدق، يملك مفاتيح المستقبل. وإذا كانت الدراما المصرية قد خطت خطوة جريئة في هذا الاتجاه، فإن على الدراما اليمنية أن تخرج من ترددها، وأن تتحرر من حسابات ضيقة، وأن تنحاز بوضوح إلى الدولة والمجتمع في مواجهة كل فكر متطرف، أياً كان اسمه أو شعاره.
الشباب العربي، في القاهرة كما في صنعاء، ليس ساحة مفتوحة للتجارب الأيديولوجية. هو طاقة بناء إن أحسنّا توجيهها، أو مشروع فوضى إن تركناه نهباً للشعارات. وبين هذا وذاك، تبقى الدراما الواعية، والتعليم المستنير، والإعلام المسؤول، خطوط الدفاع الأولى عن هوية الأمة، وعن حقها في دولة مدنية عادلة، لا ولاية فيها ولا خلافة، بل مواطنة وقانون.